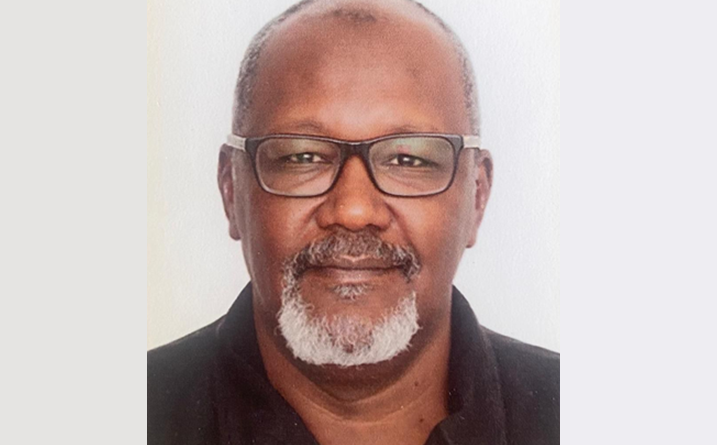ديناميات الصراع في السودان وتداعياتها على العمل الإنساني والمجتمع المدني (1-6)
كتب: عبد المنعم الجاك
مقدمة
تدخل حرب السودان في أبريل 2025 عامها الثالث في ظل ضعف أو تضاؤل أي أفق لإنهائها، عبر الحل السياسي أو الانتصار العسكري، أو التدخل الدبلوماسي الخارجي. فقد تسببت الحرب المندلعة في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أكبر وأسوأ كارثة إنسانية في التاريخ المعاصر، بتمظهراتها المدمرة على حياة ملايين السودانيين ،في سلامتهم الجسدية وأمانهم ومسكنهم وصحتهم ومعيشتهم ومعاشهم، وفي تمزيقها للنسيج الاجتماعي وتدميرها للبنى التحتية، بل وفي تهديدها لوجود كيان الدولة السودانية بتصاعد احتمالات التشظيّ.
ويشهد السياق السوداني تحولات عميقة وسريعة، اتسمت بتصاعد العنف العسكري، وتغيرات الخارطة السياسية المدنية، وتفاقم الأزمة الإنسانية، بما فيها التحديات والقيود التي تحول دون وصول العون الإنساني. وتعيد هذه التحولات الكبيرة تشكيل بيئة العمل خاصة للفاعلين في المجتمع المدني والعمل الإنساني. عليه، تعسى هذه الورقة الى تقديم وفهم المشهد السوداني المتغير دراماتيكيا بعد مرور عامين على اندلاع حرب السودان، وتأثيراتها على الفاعلين في الفضاء العام المدني والعمل الإنساني بصورة خاصة.
عبر الاستعراض والتحليل، تتطرق الورقة الى تقديم لمحة عامة عن الوضع الإنساني، وضع وبنية المجتمع المدني ،التغيرات العسكرية- الأمنية في مسرح الصراع، تطورات المشهد السياسي، التحديات والعقبات والقيود التي تقف امام العمل الإنساني والمجتمع المدني، هذا إضافة لتقديم خطوط عامة للتوصيات والاستجابات الممكن تقديمها على ضوء التحولات الجارية، بما فيها استكشاف إطلاق مبادرات ومساعٍ جديدة، تستجيب وتحمي العمل المدني والإنساني.
التوصيات الرئيسية
1. يجب أن تعكس استراتيجيات الاستجابة الإنسانية واقع التشظي الجغرافي والسياسي، خاصة في ظل وجود أربع مناطق تخضع لسيطرة أطراف متباينة في الصراع، وأن يتم اعتماد مناهج متمايزة ولامركزية وفقا للواقع تندرج تحت منظور شامل للتعامل مع الأزمة الإنسانية، ويمكن لهذا المنهج القائم على المناطق أن يسًتفيد من القدرات المتميزة والمتنوعة للمجتمع المدني المحلي والجهات الفاعلة في المجال الإنساني لتعزيز قدرتها على الاستمرار والصمود.
2. يجب أن تتعامل الجهود الدبلوماسية بصورة أكثر عملية مع التطورات السياسية والعسكرية، بما في ذلك التعامل مع تحديات قضيتيّ السيادة والشرعية، وبما يسهل عمل الهيئات والفاعليين الإنسانيين في المناطق الواقعة خارج سيطرة القوات المسلحة السودانية. ومن الممكن الاستفادة واستخلاص الدروس من العمل المقارن في تجارب اليمن وسوريا ومن تجربة عملية شريان الحياة في السودان. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي النظر في تأسيس مجلس مشترك للوكالات الإنسانية الرسمية العاملة في المناطق التي تسيطر عليها أطراف الصراع المختلفة ،وإنشاء قنوات اتصال ذات طابع مدني — وليست عسكرية أو أمنية — بين أطراف النزاع والمجتمع المدني لتسهيل التنسيق ودعم عمليات الإغاثة. ومن المهم ايضا التشديد على أن تضمن أطراف الصراع حياد العمل الإنساني واستقلاليته، ويتضمن ذلك الامتناع عن عسكرة اًلمساعدات الإنسانية، وعدم مراقبة وملاحقة المتطوعين والمنظمات والموظفين، وخفض القيود والأوامر البيروقراطية المفروضة عليهم.
3. بحث إمكانية فرض عقوبات ذكية للتعامل مع اتهامات استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب، إضافة إلى الدعوة إلى إصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعكس الأزمة الإنسانية في ظل التطورات العسكرية والأمنية والسياسية الحالية، وينبغي أن يشمل ذلك أحكاماً تتعلق بتيسير سبل الوصول إلى المساعدات ،وأمنها، ومراقبة توزيعها، وحماية جميع العاملين في المجال الإنساني .
4. المشاركة في تنظيم مؤتمر دولي حول الأزمة الإنسانية مع المجتمع المدني السوداني، يجمع قادة من المجموعات القاعدية، ومنظمات المساعدة المتبادلة، والمجتمع المدني المستقل، والتحالفات السياسية، مع الوكالات والهيئات الدولية. ويجب أن يكون المؤتمر شاملا وبقيادة وملكية جماعية في تناوله لمعالجات الأزمة الإنسانية.
وينبغي للجهات الدولية الفاعلة أن تعترف وتدعمً الخبرات المحلية المتنوعة وبما يضمن اتباع منهج شامل في العمل الإنساني.
لمحة عن الوضع الإنساني وحماية المدنيين
أكدت العديد من التقارير الدولية والمحلية أن حرب السودان تسببت في أزمة إنسانية غير مسبوقة، وتعد بكل المقاييس من أسوأ الأزمات في التاريخ المعاصر؛ حيث يقدر عدد الفارين من منازلهم بسبب الحرب بأكثر من 13 مليون شخص. وقد لجأ أكثر من أربعة منهم إلى دول الجوار. ويكابد المدنيون السودانيون تدهورا حاداً في الأمن الغذائي، إذ انزلقت العديد من المناطق الى مرحلة المجاعة الكاملة، بما فيها سوء التغذية المزمن الًذي أصاب الملايين من الأطفال والنساء المرضعات. كما تسببت الحرب في تدمير الخدمات الأساسية والبنى التحتية، خاصةً نظام الرعاية الصحية والذي أدى الى إنشار أوبئة الكوليرا وحمى الضنك والملاريا، كما أدت الحرب إلى انهيار النظام التعليمي بما أدى إلى انقطاع نحو 17 مليون طفل من العملية التعليمية، من إجمالي 19 مليون طفل في سن التعليم تم حرمانهم منه.
كما أكدت التقارير على استخدام أطراف الحرب للغوث الإنساني كسلاح ضمن الاستراتيجيات الحربية، بوضع العراقيل والعقبات أمام إيصاله، والهجمات المتعمدة على البنىّ التحتية والخدمات الخاصة بإنتاج الغذاء، وبالتالي التجويع المتعمد للمدنيين، بمن فيهم الأطفال.
وبالنظر الى وضع حماية المدنيين بعد عامين من الحرب، تطل صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان في السودان؛ حيث تستمر انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان من قبل جميع أطراف النزاع بمستويات مقلقة.
وتشمل الانتهاكات والجرائم المرتبطة بالحرب على الهجمات المتعمدة والعشوائية ضد المدنيين بما فيها قصف المناطق السكنية ومخيمات النزوح وسقوط القتلى من المدنيين جراء ذلك، والإعدامات الميدانية الانتقامية خاصة في المناطق التي يتم فيها إعادة السيطرة العسكرية من قبل الطرف الآخر، والاستهداف المنهجي على أساس الهوية ،والوحشية في عمليات التعذيب والتصفيات الجسدية، واستخدام العنف الجنسي والاغتصاب الجماعي كوسيلة للترويع والارهاب، والاختطاف والاحتجاز القسري واستخدام المدنيين كدروع بشرية، والتجنيد القسري للأطفال والزج بهم في المعارك العسكرية والنهب والتدمير الممنهج للممتلكات والمنازل والمؤسسات الخدمية من كهرباء ومياه ومرافق صحية وتعليمية، واحتلال المنازل من قبل الجنود، والتهجير القسري والنزوح الجماعي للملايين.
وإذا ما نظرنا للوضع الإنساني وحماية المدنيين، نجدها، وبالرغم من تعدد وتنوع الجهود لحلها، دولياً ومحليا، تظل محدودة وضعيفة النتائج. وتتعدد أسباب الفشل لتشمل التعنت وافتقار الإرادة السياسية لأطراف الحرب بًالسماح بإغاثة المدنيين وحمايتهم، وعدم الاتفاق على ممرات آمنة لإيصال العون، واستخدام أطراف الحرب للأوضاع الإنسانية كسلاح في اقتتالهم، وضعف وسائل ضغوط المجتمع الدولي على أطراف الحرب فيما يتعلق بحماية المدنيين والعملية الإنسانية وافتقارها للجرأة، وعدم إيفاء المانحين بالتزامات تمويل الاحتياجات الإنسانية، ووضع أعباء كبيرة وغير واقعية على مقدمي الخدمات المحليين من المتطوعين ومنظماتهم القاعدية مثل غرف الطواري وتكايا الطرق الصوفية والمطابخ المركزية، إضافة الى عدم الجدية في إشراك القوى المدنية والسياسية المؤثرة في عمليات تطوير الاستراتيجيات والخطط الخاصة بأنشطة العمليات الإنسانية. (يتبع)