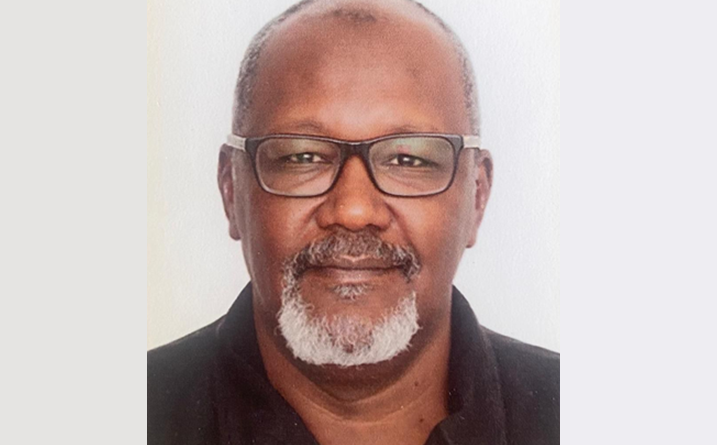ديناميات الصراع في السودان وتداعياتها على العمل الإنساني والمجتمع المدني (4-6)
كتب: عبد المنعم الجاك
مشهد المجتمع المدني
منذ استقلال السودان في 1956، لعبت منظمات المجتمع المدني دورا محوريا في عمليات التغيير، والتنوير، وتقديم الخدمات، والإصلاح السياسي والاقتصادي والتطوير الاجتماعي والثقافًي. وتضمً هذه المنظمات، على سبيل المثال لا الحصر، أندية الخريجين والعمال، الجمعيات الثقافية والأدبية، الأندية الرياضية، والروابط الإقليمية والمهنية، ونقابات العمال والمزارعين، والشباب والطلاب، والمجموعات النسائية، والجمعيات المحلية والقاعدية، فضلا عن التنظيمات والأحزاب السياسية. وقد كان دور منظمات المجتمع المدني أساسيا في التأثير على السياسات المتعلًقّة بالديمقراطية ،وصناعة وبناء السلام، والعمل الإنساني، والتنمية. وقد تجلتّ هذا الأدوًار في قمتها بمشاركة وقيادة المجتمع المدني الفاعلة في نضالات السودانيين من أجل الاستقلال، وفي قيادة الانتفاضات الشعبية في أكتوبر 1964، وفي 1985، وفي ثورة ديسمبر 2018، وهي النضالات التي نجحت في إسقاط ثلاثة أنظمة عسكرية دكتاتورية عبر الإضرابات العامة والعصيان المدني السلمي، وساهمت لحقب متفاوتة في استعادة التحول الديمقراطي وإسكات البنادق ببناء السلام .
مثلما أحدث اندلاع حرب السودان في 15 أبريل 2023 زلزالا كبيرا في المجتمع والدولة السودانية، فقد تسببت الحرب كذلك في تحولات جذرية حول طبيعة وادوار ومستقبل المجًتمعً المدني السوداني. ويمكن القول بأنه باتساع رقعة الحرب في السودان، كما هو حادث الآن، تتشظى وتتقلص مساحات العمل المدني السلمي.
حيث نجد أن تطورات الحرب في السودان والانقسامات الجغرافية والجهوية التي أحدثتها، قد أوجدت كذلك انقسامات الى أربع مناطق متميزة يعمل فيها المجتمع المدني، وتختلف أنماط وقواعد وطرق عمله تحت أيا منها. وتشمل هذه السياقات، المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة السودانية، المناطق الخاضعة لسيطرة قوًات الدعم السريع ،والمناطق تحت سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، والمناطق التي تسيطر عليها حركة تحرير السودان.
وعلى الرغم من هذه الانقسامات المناطقية، يمكن الحديث عن خمس فئات رئيسية للمجتمع المدني ،تتداخل أدوارها ومجالات ومناطق عملها وتحدياتها التشغيلية، حيث تشمل:
1. المجموعة الأولى تتكون من المنظمات غير الحكومية الحديثة، التي يتطلب عملها التسجيل الرسمي والحصول على اذونات العمل من الهيئات التنظيمية الحكومية، مثل مفوضية العون الإنساني. وعادة ما تشمل مجالات عملها قضايا التنمية المجتمعية، والثقافة، والحقوق السياسية والمدنية، والبيئة، والتنمية، وتقديم الخدمات. وقد واجهت هذه الفئة صعوبات عديدة بعد اندلاع حرب 15 أبريل، حيث اضطر معظمها الى النزوح والتهجير داخل وخارج السودان، أو تعليق عملها، كما اضطر بعضٌ منها إلى تغيير مجالات العمل ليشمل توفير الاحتياجات الإنسانية>
2. المجموعة الثانية تضم منظمات المجتمع المدني التي عملت تاريخياً في مناطق الصراع في دارفور، والنيل الأزرق ،وجبال النوبة. حيث تركز هذه المنظمات مجهوداتها على تقديم الخدمات والغوث الإنساني وبناء السلام والأنشطة المجتمعية مع المجتمعات المحلية والنازحين داخلياً، وقد مكنتها خبراتها الطويلة في مناطق الصراع على التكيف والصمود على الرغم من التأثير المدمر للحروب.
3. المجموعة الثالثة تتمثل في المنظمات القاعدية والأهلية المحلية القائمة على الأسس الدينية أو الإثنية أو المناطقية ،وتستهدف مجالات عملها خدمة وتلبية الاحتياجات الأساسية لمجتمعاتها، وهي ذات طبيعة قاعدية لا تتجاوز معارفها وطرق عملها مجتمعاتها المحلية.
4. اللمجموعة الرابعة تشمل منظمات الاستجابة لحالات الطواري والتي نشأت بعد حرب 5١ أبريل، وتعمل بصورة رئيسية في تسهيل المساعدات الإنسانية وتوفير بعض التدابير لحماية المدنيين. ومن أمثلتها غرف الطوارئ ،المطابخ المجتمعية، المجموعات الدينية وتكايا الطرق الصوفية، ولجان الأحياء، وغيرها من مجموعات محلية قاعدية طورت من خبراتها السابقة أو نشأت حديثا للاستجابة للأزمة الإنسانية الطارئة. كما تضم هذه الفئة مجموعة من المنظمات التي تأسست بعد الحرب في مناطقً وأقاليم لم تكن تشهد وجود ملموس للمجتمع المدني الحديث ،مثل ولايات نهر النيل والشمالية، وجاء تكوينها بعد موجات النزوح من وسط السودان الى هذه المناطق.
5. الفئة الخامسة من تكوينات المجتمع المدني تشمل المنظمات في المنافي، وهي مجموعات قديمة ظلت موجودة قبل الحرب، تتفاوت قضايا اهتمامها وفق احتياجات الأوضاع في السودان – من المناصرة حول انتهاكات حقوق الإنسان، إلى قضايا التنمية، إلى التطوير والتبشير الثقافي وسط مجتمعات المهاجرين. وبعد حرب 15 أبريل طورت مجموعات المنافي من أدوارها في المساهمة ودعم العمل الإنساني بصورة كبيرة من خلال جمع التبرعات والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية. ومع ذلك تطالها بعض الانتقادات بسعي بعضها للعب أدوار قيادية إنابة عن المنظمات المحلية، أو قيامها بمهام تنفيذية ميدانية.
وتنتشر الفئات الخمس في المناطق الجغرافية الأربع المشار لها، كما تشترك في محافظتها وتطويرها للقيم الأساسية للمجتمع المدني، مثل المشاركة، والشفافية، والتمثيل، والاستقلالية، والطوعية، فضلا عن مبادئ العمل الإنساني الأربع: الإنسانية، والحياد، وعدم التحيز، والاستقلالية. ومع ذلك، فإن تداعيات حرب 15 أبريل شكلّت تحديات جسيمة للمحافظة على هذه القيم وحمايتها. فعلى سبيل المثال، تعرضّت منظمات المجتمع المدني في مناطق الصراع لضربات قاسية أثرّت على قدرتها على التمثيل الميداني والحضور المجتمعي، وفي الوقت نفسه أظهرت المجموعات القاعدية ومجموعات الاستجابة للطوارئ قدرات عالية من التكيّف والصمود أمام ظروف الحرب الكارثية، رغم القيود الكبيرة التي تواجه عملها.
وعلاوة على ذلك، تشكل قضايا مثل الالتزام بمبادئ العمل الإنساني مثل المساءلة والحياد والاستقلالية تحديات معقدة للعديد من المنظمات المحلية، سواء في علاقاتها مع أطراف الصراع أو في تفاعلاتها مع الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في السودان. وتشمل هذه القضايا التعدد، وفي بعض الحالات التناقض، بين مستويات المحاسبية للمجموعات المحلية ) تجاه المانحين وسلطات الامر الواقع والمجتمعات المستفيدة( حيث تشمل في بعض الحالات دول ونظم قانونية وإدارية مختلفة. وهو ما ينطبق كذلك على القيود التي تحد من مقدرات المجموعات المحلية في المرونة والتكيف وأساليب الصمود المختلفة التي تعتمدها في عملها العابر لخطوط النار ولجغرافيات الصراع، خاصة فيما يتعلق بأدوارها في التفاوض المستمر ونسج العلاقات وبناء الثقة مع أطراف الصراع لتسهيل عملها على الأرض ولتخفيف المخاطر الأمنية التي تواجهها يومياً.
وفي ظل تراجع دور الدولة ومحاولات عسكرة مجمل الفضاء المدني، تدور حوارات ونقاشات مستمرة حول الأدوار الممكنة حاليا والمستقبلية للمجتمع المدني في ظل استمرار وتتمدد الحرب بآثارها المتعددة. وتشمل هذه الحوارات كيفية التعاملً مع مستويات الانقسامات المتعددة التي يمر بها السودان، وإعادة تحديد وترتيب أولويات المجتمع المدني، خاصة فيما يتعلق بالمناصرة ودعم جهود تقديم المساعدات الإنسانية.
يواجه، عموما، المجتمع المدني في السودان ،في ظلال حرب 15 أبريل، مجموعة واسعة من التحديات والمخاطر، تشمل – دون أن تقتًصر على – انعدام الأمن والعنف المستمر، الاستهداف الممنهج وسلامة وأمن الفاعلين فيه، إشكالات التمثيل والشمول، الاستقلالية والحياد، البنية التنظيمية الداخلية للمنظمات، تعقيدات الاتصال وتدفق المعلومات ،المبادئ والقيم الحاكمة، والعلاقات مع الشركاء الدوليين. هذا إضافة للقيود المتزايدة باتساع وتعقد الحرب، من تشرذم واستقطاب وانقسامات جهوية وجغرافية وإثنية طالت المجتمع المدني، وتأثيراتها الناتجة مثل الاصطفاف والتسييس والعسكرة وفقاً للجغرافية والبيئة التي تعمل فيها المنظمات.
وعلى الرغم من المخاطر والتحديات الكبيرة التي يواجهها المجتمع المدني بعد الحرب، فقد تمكنت العديد من المنظمات من خلق أدوار وأدوات جديدة، مستمدة من معارفها المحلية وخبراتها التاريخية، أتاحت لها مقدرة نسبية على الصمود والاستمرارية، بما فيها محاولات التكيف والتعامل مع سلسلة التحديات والعقبات المنهجية التي تضعها أطراف الحرب أمام عمل منظمات المجتمع المدني. (يتبع)