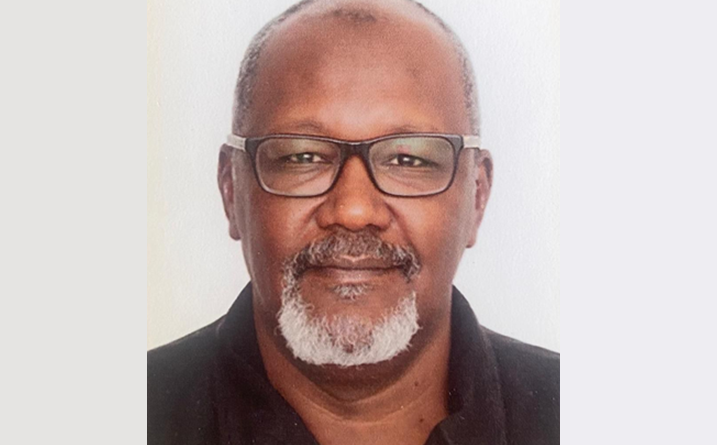الصراع في السودان وتداعياتها على العمل الإنساني والمجتمع المدني (5-6)
كتب: عبد المنعم الجاك
التحديات وعقبات العمل الإنساني والمجتمع المدني
ظلت منظمات المجتمع المدني السوداني المستقلة تعمل على مدى عقود تحت ظل تحديات وقيود وعقبات مستمرة من قبل مؤسسات الدولة السودانية، وبصورة خاصة خلال سيطرة نظام حكم حزب المؤتمر الوطني منذ 1989، حيث عانت حريات التجمع السلمي وتكوين الروابط والجمعيات من انتهاكات منهجية، لا تختلف كثيراً عن التجاوزات التي طالت مجالات الحريات وحقوق الإنسان.
وجاءت حرب 15 ابريل 2023 فاتحة المجال لحقبة جديدة من فرض القيود والعقبات على عمل منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات القاعدية والمحلية التي نشأت أو اكتسبت أدوارًا جديدة في تقديم الخدمات والعون الإنساني بعد الحرب. ويمثل تسيس وعسكرة العمل الإنساني ونشاط المجتمع المدني السمة البارزة في حقبة الحرب، يتم خلالها استخدام وسائل واستراتيجيات متعددة من القيود ووضع العقبات للحد من استقلالية عمل المنظمات وفاعليتها.
وتختلف مساحات العمل والقيود على العمل الإنساني والمجتمع المدني وفقا للسياق الجغرافي والعسكري-الأمني الذي تتحكم فيه أطراف الحرب. حيث تقوم واجهات مدنية بتنظيم وتنسيق عمل المجتمع المدني وفقا للمنطقة الجغرافية، وفقا لأطراف الصراع؛ حيث نجد مفوضية العمل الإنساني تقود عمل المنظمات في مناطق سًيطرة القوات المسلحة، والوكاًلة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية في مناطق سيطرة الدعم السريع، ووكالة الإغاثة وإعادة الإعمار في مناطق سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، فيما تشرف الهيئة العامة للعمل الإنساني والمنظمات في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان .
وبالرغم من وجود هذه المؤسسات المدنية – الحكومية وشبه الحكومية – لتنظيم وتنسيق عمل المجتمع المدني، إلا أن التسيس والعسكرة تمثل السمة الرئيسية المحركة لعملياتها، وبصورة خاصة في مناطق سيطرة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.
ويمكن، استناداً على هذه الخلفية، تلخيص التحديات والعقبات والقيود التي تواجه العمل الإنساني والمجتمع المدني بعد حرب 5١ أبريل في القضايا التالية:
١. اتساع دائرة الحرب وآثارها لتشمل معظم أقاليم السودان، مما أدى إلى انعدام الأمن وانتشار العنف، وانهيار البنية التحتية وغياب الخدمات الأساسية، فضلا عن المخاطر الأمنية اليومية التي يتعرض لها العاملون في المجتمع المدني والإنساني من تهديد للحياة والإصابًات والاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري وتقييد الحركة.
2 . تعدد مناطق السيطرة والنفوذ العسكري-الأمني، وتفتت السلطة المركزية وغياب حكومة موحدة لها القدرة على تنظيم وتنسيق العمل الإنساني وانشطة المجتمع المدني، بما فيها تعدد الكيانات الموازية لسلطة الدولة.
3. تقلص الفضاء المدني إلى أدنى درجاته ،واضطرار غالبية منظمات المجتمع المدني القومية وذات الخبرة والتجارب الطويلة للنزوح داخليا وخارجيا بسبب الحرب ومترتباتها.
4. بالرغم من الأدوار العظًيمة للمؤًسسات القاعدية في تقديم الخدمات الإنسانية، مثل غرف الطواري ومطابخ المركزية وتكايا الطرق الصوفية والروابط الجهوية والإثنية، إلا أن اتساع دوائر الحرب والانقسامات المجتمعية والجغرافية وحجم الأزمة الإنسانية ،يضعها أمام سلسة من التحديات الكبيرة تتجاوز مقدراتها وخبراتها.
5. صعوبات التنسيق والعمل المشترك بين المنظمات المحلية القاعدية على المستويات الرأسية – اتحاديا أو إقليميا أو ولائياً – بسبب اختلاف بنياتها وخلفياتها وخبراتها، فضلاً عن الانقسامات الجغرافية والجهوية التي تسًببت فيها الحًرب.
6. ضعف القدرات الإدارية والتنظيمية الداخلية للعديد من تنظيمات المجتمع المدني، خاصة القدرات الفنية المرتبطة بإجراء المسوحات والتقديرات وكتابة المشروعات والتقارير، وطرق ووسائل التواصل والعمل مع الهيئات الدولية والمانحة
7. التعقيدات الأمنية المرتبطة بالحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة، وتعقيدات عمليات الاتصال وتبادل وتدفق المعلومات، والإعلام والنشر، والأخبار الكاذبة والمضللة، بما فيها تحديات انقطاع التيار الكهربائي وشبكات الاتصالات والإنترنت.
8. التحديات والعقبات المرتبطة بسياسات وإجراءات مفوضية العون الإنساني في تنظيم عمل المنظمات المحلية والدولية، بما فيه البيروقراطية المفرطة؛ حيث تتسم عمليات تسجيل المنظمات وتجديد تراخيصها وحركة منسوبيها والتصاريح المسبقة بدرجة عالية من التعقيد والتعطيل، وفرض رسوم عالية على المنظمات، ومحاولات السيطرة على عمليات التوظيف ومناطق العمل وتقييد الحركة. كما يشمل فرض قيود العمل البيروقراطية، بدرجة أقل ،الوكالات الرسمية للعمل الإنساني خارج مناطق سيطرة الجيش.
9. التحكم والسيطرة الأمنية-العسكرية على العمل الإنساني بإنشاء اللجنة المشتركة العليا للطوارئ الإنسانية ،برئاسة أحد قادة الجيش وعضو لمجلس السيادة، والعضوية الطاغية لممثليّ الأجهزة الأمنية، والهيمنة على أدوار مفوضية العمل الإنساني الإتحادية والولائية، بفرض عناصر أمنية في جميع أنشطتها.
10. تنافس أطراف الحرب في ادعاء الشرعية وممارسة السيادة للحصول على المساعدات الإنسانية وتأمين إيصالها وتوزيعها. ويشمل ذلك الصراع على منافذ السيطرة مثل سيطرة القوات المسلحة على الإغاثة القادمة عبر مطار وميناء بورتسودان، والمعبر مع جمهورية مصر، وسيطرة الدعم السريع على عدد من المطارات والمعابر الحدودية مع نحو أربع دول. فضلاً عن سيطرة القوات المشتركة الموالية للقوات المسلحة على العديد من مناطق التماس العسكرية
١١. تسيس العمل الإنساني بإنشاء واجهات مدنية من التنظيمات والتشكيلات العسكرية المشاركة في الحرب للعمل في المجتمع المدني والمجال الإنساني، بمنحها تصاديق من مفوضية العمل الإنساني، استناداً إلى ولاءات سياسية أو إثنية أو علاقات مع أطراف النزاع، وتسهيل حركتها واتصالاتها مع هيئات العون الخارجي.
12. بسبب طول أمد الحرب، وهيمنة خطاباتها – حرب الكرامة والسيادة مقابل حرب إزالة التهميش وتفكيك الدولة القديمة – اصطفت مجموعة محدودة من المنظمات المدنية مع أطراف الصراع، بالتماهي غير المباشر مع خطاباتها، وبتوظيف قدراتها وإمكاناتها المهنية في دعم هذا الطرف أو ذاك.
13. التلاعب بالمساعدات الإنسانية، خاصة القادمة من الدول العربية والتي يتم تسليمها للسلطات الرسمية ،وتوجيهها لدعم المجهود الحربي وفقا لمناطق السيطرة، حيث توجد العديد من الشواهد والصور المنشورة على انتشار المساعدات في المناطق العسًكرية وعند الجنود عليها شعارات الهيئات والدول المانحة.
14. نهب وبيع المساعدات الإنسانية في الأسواق، خاصة القادمة من الدول العربية والتي يتم تسليمها للسلطات الرسمية، وتوجيهها لدعم المجهود الحربي وفقا لمناطق السيطرة؛ حيث توجد العديد من الشواهد والصور المنشورة على إنشار المساعدات في المناطق العسكرية وًعند الجنود عليها شعارات الهيئات والدول المانحة.
15. توظيف المساعدات الإنسانية في الدعاية السياسية وإيهام الرأي العام بحرص الأطراف المتحاربة على أوضاع النازحين ومحاولة كسب تأييد المواطنين بتوزيع مواد العون الإنساني، حيث ظهر ذلك بصورة أوسع في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع في مناطق الجزيرة والخرطوم.
16. على الرغم من تنظيم عدد من المؤتمرات الدولية لحشد الدعم الإنساني ومساعدة ضحايا حرب 15 أبريل ،إلا أن الاستجابة والإيفاء بما يتم الالتزام به يتقاصر عن حجم الاحتياجات ،وتُصنف الأزمة الإنسانية في السودان بأنها الأسواء في العالم المعاصر.
17. غياب الحلول والمقترحات غير التقليدية والبراغماتية في التعامل مع الأزمة الإنسانية من قبل المجتمع الدولي، والتركيز بصورة اكبر على دعم الحلول المحلية بتحميل المجموعات القاعدية اكبر من مقدراتها وخبراتها، بما فيها تعريضها لمخاطر العنف.